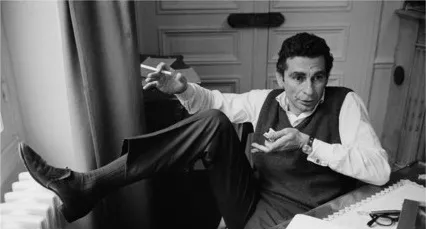في أحد مشاهد «اليوم السادس» (1986) (الذي أهداه يوسف شاهين لـ«جين كيلي» أسطورة أربعينيات وخمسينيات هوليود دون غيره)، خلال حوار داخل البيت بين «صِدّيقة» (داليدا) و«سعيد» (حمدي أحمد)، يتحوَّل شُباكهما ذو القضبان الملتوية إلى شاشة داخل الشاشة تتوالى عليها اللقطات. هكذا يتجاور ما نفهمه من عتاب زوجين حول تاريخهما ليس فقط مع ما يتابعانه ويعلِّقان عليه في محيطهما – من سطوة المِعَلِّمة «زكية» (سناء يونس) إلى فرار القُرَدَاتِي «أوكا» (محسن محيي الدين) وقد قررت جماعة من التلاميذ الوطنيين أن يضربوه لأنه متنكر في زي جندي إنكليزي، مرورًا بالعودة المتأخرة لحفيد «صديّقة» الصغير «حسن» (ماهر عصام) الذي تنتظره بقلق وقد ظهرت عليه أعراض الكوليرا – ولكن مع الخطوط الدراميَّة الموازية التي تمدُّها كلُّ لقطة. إنَّها متتاليةٌ باهرةٌ حقًا تطرح شبكةً كاملةً من الحالات الإنسانيَّة من زاويةٍ ذاتيَّة – في مقابل زاويةٍ موضوعيَّة – على أكثرِ من صعيد...
كَيْفًا إن لم يكن كَمًّا، كان النصف الثاني من ثمانينيَّات القرن الفائت زمنَ ازدهارٍ استثنائي في السينما المصريَّة، حيث لم يقع المجال فريسةَ البحث المحموم عن النجاح في الغرب بعدُ، بدءًا من الإنتاج وليس انتهاءً بالعرض في أحد المهرجانات الكبرى، وهو ما يحلُّ محلَّ التحقُّق العضوي داخل المجتمعات الناطقة بالعربيَّة اليوم في ظلِّ تراجع الفن لصالح التنميط التجاري واضمحلال السوق بشكلٍ عام، بل ويمهِّد للاستحواذ على فضاءٍ "إقليمي" هو الآخر يقتصر على المهرجانات وبيوت الفن. عام 1985، بقيت هناك مساحة حقيقيَّة للجمع بين التجديد الإبداعي وإرضاء ذائقة قطاعٍ واسعٍ من محبي السينما ما يزال يدعم – أو يساهم في دعم – صناعةٍ محليَّة. خلال السنوات الخمس التالية، وفي سياق حركة «الواقعيَّة الجديدة» (والتي ساهم فيها أيضًا عاطف الطيب وداود عبد السيد)، ربَّما أنجز خيري بشارة ومحمد خان أقوى أربعة أعمال لهما (وكل منها استحضارٌ جماليٌّ للواقع "كما هو" وإجابةٌ ناجعةٌ عن سؤال كيف تكون السينما "الجادة" سينما ممتعة في الوقت نفسه، أو كيف يحظى فنُّ الشاشة الفضيَّة بإقبالٍ جماهيريٍّ دون أن يتخلَّى عن انحيازه الجمالي، وبغض النظر عن الإنتاج المشترك والجوائز وسائر بروتوكولات الرواج المستوردة): «الطوق والأسورة» (1986)، «زوجة رجل مهم» (1987)، «يوم حلو، يوم مر» (1988)، «أحلام هند وكاميليا» (1989).
ولا أدري ماذا كان رأي شاهين في هذه الأعمال الأربعة وهو رائد سينما المؤلِّف الذي مهَّد الطريق إلى الحضور العربي في أوروبا والغرب أساسًا، محقِّقًا ضربًا من النجاح جانَبَ مخرجي الواقعيَّة الجديدة إجمالًا، كما جانب سواهما من فنَّاني السينما العرب رغم أنَّهم يستحقُّونه ربما أكثر من بعض أشهر الأسماء "العالميَّة" غير العربيَّة. لكنَّ الفترة نفسها شهدت ثلاثة أعمالٍ لشاهين هي الأخرى ذات شأنٍ فنيٍّ بغض النظر عن ملابسات إتمامها واستقبالها هنا وهناك: «الوداع يا بونابرت» (1985)، «اليوم السادس» (1986)، «إسكندرية كمان وكمان» (1989). كانت هذه المرحلة الأخيرة من إبداعه هي الأكثر إثارةً بالنسبة إليَّ في مسار شاهين ككل: مرحلة سينما المؤلف التي بدأت بـ«إسكندرية ليه» (1978) وانتهت بـ«المهاجر» (1994)، متضمنة رباعيَّة سيرته الذاتية التي يمثِّل «إسكندرية كمان وكمان» ثالث أجزائها، وإن وقع الجزء الرابع «إسكندرية نيويورك» (2004) خارج المرحلة بالكامل، سواء من الناحيتين الزمنيَّة أو الفنيَّة.
يبدو أن ما يميِّز هذه المرحلة عن خَبَطات شاهين المبكِّرةَ التي تفضِّلها الذائقة التقليديَّة حتى اليوم – «صراع في الوادي» (1954)، «باب الحديد» (1958)، «الناصر صلاح الدين» (1963) – كونها أدخَلت على السينما العربيَّة ذاتيَّةً غير مسبوقةٍ فعلًا، إذ خاطبت، فضلًا عن الجمهور المحلي (أم عوضًا عنه؟)، جمهورًا أكثر تجرُّدًا، أو لعلها خاطبت الإنسانيَّة كلَّها وإن تمثَّلت في أرباب الفنِّ والفكر الغربيِّين (غير المعنيين اليوم كما اتَّضح إلا بأفكارهم الاستشراقيَّة عن العالم الإسلامي: قمع المرأة، التطرُّف الديني والعنف السياسي وما إلى ذلك من خطابٍ استعماريٍّ كذوب). لعلَّ الأمور، في الثمانينيَّات، لم تبلغ هذا الحال من التردي: حيث سينمانا العربيَّة في عزلةٍ عن جمهورها. وحيث سينما "العالم الثالث" ككلٍّ لا تظهرُ منها غير السينما الإيرانيَّة التي يُحتفى بها بوصفها مقاومةً فنيَّةً لنظام حكمٍ معادٍ لـ"العالم الأوَّل" ليس أكثر.
شأنها في ذلك شأن المرحلة بأسرها، تنشغلُ أفلام شاهين الثلاثة المذكورة أعلاه بالتاريخ. هذا الانشغال لا يُحصرُ كموضوع، إنَّما أيضًا كمساحةٍ جماليَّةٍ متعدِّدة المستويات، تتداخلُ الوقائع ومعانيها المتعمدة مع الأحداث والثيمات دونما أن تفرضها بالضرورة، وتمثِّل إسقاطاتٍ مباشرةً أحيانًا على الواقع الراهن (الناصر صلاح الدين محرِّر القدس كاستدعاءٍ لعبد الناصر قبل الهزيمة). كما تميلُ إلى النزعةِ الاستعراضيَّة متمثِّلةً في الغناء والرقص المتمركز حول البطل الشاب الممسوس بنشاطِ وطاقة شاهين شخصيًّا، وكأنَّه نسخة منه (يلعب هذا الدور محسن محيي الدين في «اليوم السادس» و«الوداع يا بونابرت»). غير أنَّ «اليوم السادس»، بتصوير محسن نصر الذي يوازن بين الداخلي والخارجي بشعريَّةٍ باهرة، هو العمل الذي تتجلَّى فيه الذاتيَّة «الشاهينية» على أوضح وربما أعذب صورة. إنَّه العمل الفاصل حيث في التاريخ والاستعراض وسواهما – بعيدًا عن سيرة حياة شاهين نفسه – يأخذان رؤيةً فريدةً متَّسقةً للحياة الإنسانيَّة. أقصد أنَّ فيها فن!
تظهرُ فترة حكم الملك فاروق في الملابس وتفاصيل الحياة اليوميَّة – تصميم الملابس لناهد نصر الله وإيفون دو نسله، والديكور لطارق صلاح الدين – كما تظهر في أنماط ومهنِ الشخصيَّات من أبناء الشعب وصلاتهم بطبقة السرايا المعزولة عنهم من جهة، وحضور الإنكليز المحتلِّين من جهة أخرى. لكنها تظهر، قبل هذا وذاك، في اللحظة الكارثيَّة التي تُحدِّد مسار الأحداث: وباء الكوليرا الذي ضرب ربوع مصر على خلفية حرب فلسطين بين عامي 1947 و1948... ومع ذلك، ليس هذا كله إلا خلفيَّةٍ لأمرين: أولهما أن الفلَّاحة «صِدّيقة» (تمثيل المغنية الفرنسيَّة ذات الأصل الإيطالي-المصري داليدا، في آخر دور لعبته قبل انتحارها سنة 1987) تحاول أن تُنقذ حفيدها الذي أصابته العدوى من الاحتجاز والموت، عازمةً أن تُريه البحر، عن طريق الهروب به شمالًا عبر النيل. وثانيهما أنَّ جارها القُرَدَاتي «أوكا»، المُسمّى على اسم قرده (محسن محيي الدين)، وهو يساعدها في الهروب ويسعى إلى اصطحابها أيضًا، واقعٌ في غرامها مع أنَّه يصغرها سنًّا. إنَّها تبادله إحساسه كما يبدو، لكنَّه لا ينالها في النهاية لأنَّها لا تستطيع أن تستجيب لرغبتها، حيث أنَّها امرأةٌ متزوِّجةٌ وزاهدة في المباهج الشخصيَّة إلى حدٍّ بعيد.
ليست الذاتيَّة هنا في طرح موضوعٍ تاريخيٍّ "عام" من زاوية تلك العلاقة الغراميَّة "الخاصة" فقط، ولا في غرابة صلة الجدَّة بحفيدها في ظلِّ غياب الأبوين، أو خصوصيَّة التكوين الاجتماعي لحياتهما مع زوج صِديّقة القعيد سعيد (حمدي أحمد) في منطقةٍ شعبيَّةٍ تتداخل فيها قوى وتوجُّهات المجتمع وكأنَّها نموذجٌ مصغَّرٌ للبلد كله في تلك اللحظة. إنَّ الذاتيَّة تكمن أساسًا في النبرة الهستيريَّة التي يُطرح بها كلُّ هذا – وهي هستيريَّة شاهين التي تتجلَّى في شخصيَّات أفلامه جميعها، بالذات في الشاب الذي يتقمَّصه بغضِّ النظر عن طبيعة الدور الذي يلعبه – أو في زاوية نظرٍ قادرةٍ على الخلط بين أهواء أو مآرب ضاربةٍ في عمقٍ في النفس وحالات اجتماعيَّةٍ-ثقافيَّةٍ لا تتماشى بالضرورة مع تلك المآرب. إن لَكنة داليدا في نطق العربيَّة الفلاحيَّة على لسان صِديّقة مثلًا كفيلةٌ بفضح هويَّتها المفارقة تمامًا لحقيقة الشخصيَّة، إلا أنَّها في الواقع الموازي – الحلم – الذي يخلقه العمل تمرُّ بسلامٍ وكأنَّها مجرَّد تفصيلةٍ غريبةٍ في لوحةٍ لا خلل في خطوطها وألوانها وإن كانت ترسم مشهدًا يقترب من الواقع دونما يطابقه أو يستحضره كما هو.
سيموت حسن… طبعًا سيموت، قبل أن يرى البحر. سيودِّع أوكا صِديّقة. لكن سنرى الشمس تطلعُ على الماء قبل ذلك، وسنسمع صوت محمَّد منير يؤدي كلمات صلاح جاهين «بعد الطوفان الجو شبورة، ننده لبعض بهمسة مذعورة. بشويش نمد الإيدين، ياللي إنت جنبي إنت فين» وقد ظهر صحبة الممثل العراقي يوسف العاني في بضع لقطاتٍ لا أكثر، إنَّهما فريق الملاحة على المركب المتواضع الذي تُخفي فيه صديقة حفيدها وهما سارحان صحبة أوكا شَمالًا، شمالًا نحو الماء المالح. تكون موسيقى عمر خيرت المؤلَّفة خصيصًا للفيلم أدَّت وظيفتها على أكمل وجهٍ شاهيني، وقد عانقتنا روح المؤلف قبل أن نعرف عنه شيئًا.